
حقوق الإنسان الملف الساخن على أجندة «القاهرة - واشنطن»
فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى، وحين تم الإعلان عن تأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والتى كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان فى الدول العربية، لم يكن الأمر ببعيد عن أعين ورقابة ساكنى «البيت الأبيض « والأجهزة التابعة لهم، وعلى الفور تفتق ذهن القائمين على إدارة ملفات العلاقات مع دول الشرق الأوسط، وفى القلب منها مصر، على أن تكون كلمة السر الجديدة فى إدارة التعامل مع الحكومة المصرية هى «حقوق الإنسان «، وهو ما كان عبر سنوات امتدت منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، وجرى خلالها فى نهر الأحداث مياه كثيرة، تفاوتت فى حدة اندفاعها، ووصلت فى بعض الأحيان إلى حد بعض من القطيعة، تحت لافتة «حقوق الإنسان»، وتبادل للتصريحات الساخنة بين القاهرة وواشنطن، تبدأ بانتقاد يوجهه مسؤول أمريكى لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وترد القاهرة حينا وتسكت أحيانا أخرى.
تشكيل أول إدارة للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان جرى عبر اجتماع عاصف بجمعية الاقتصاد والتشريع، أسفر عن تكوين مجلس الأمناء الأول بتشكيل ضم بعضا من القوميين العرب والشيوعيين والمنتمين إلى الحزب الوطنى القديم، بزعامة فتحى رضوان، وهو المجلس الذى اختار الكاتب اليسارى المعروف الدكتور شريف حتاتة كأول أمين عام للمنظمة الوليدة.
بحسب الناشط الحقوقى البارز نجاد البرعى فإن «المتأمل لأسماء كل الذين تصدوا للعمل على إنشاء جمعيات أو تجمعات أو منظمات حقوقية عقب ذلك، سوف يكتشف أنهم كانوا من النخب السياسية القديمة بألوان طيفها المتعددة، من الوفد إلى الناصريين فاليسار المصرى بدرجاته المتنوعة، ومن هنا فإن النظرة العامة لهذا النوع من المؤسسات، كان ينحصر فى أنها جمعيات للنخب المحبطة سياسيًا، وغير القادرة على دفع تكاليف العمل السياسى، فكان النشاط الرئيسى لتلك الجمعيات أشبه بالمنتديات الفكرية التى «يتشرنق» فيها أصحابها، ممن يتصورون أنهم صفوة المجتمع، ويناقشون فيها قضايا ذات طبيعة فكرية.
لم يكن ما بدأ ظهوره على الساحة المصرية، التى كان الركود سمتها الرئيسية فى ذلك الوقت ببعيد عن متابعة ورقابة عواصم الغرب وأجهزة حكوماته، وكان المنتظر هو الوصول إلى نقطة تلاق، غير ما ترفعه تلك الحكومات من شعارات الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وما بدأ النشطاء المصريون فى صياغته من مطالب أو بالأدق توصيات لمنتدياتهم الفكرية، قريبة من الشعارات الغربية فى هذا الشأن، وكانت كلمة السر هذه المرة فى «التمويل «، فتلك الحكومات وعلى رأسها الحكومة الأمريكية تخصص بعضا من فوائض ميزانياتها لدعم برامج الديمقراطية حول العالم، والحركة الحقوقية الناشئة فى مصر، لم تبد تمنعا فى قبول الدخول على خط تلقى التمويلات، وكانت - وما زالت - الأسباب المعلنة لذلك التوجه، هى تضييق الحكومة على سعى نشطاء الحركة الحقوقية للحصول على تمويل خارجى لأنشطتهم، وحاجتهم إلى توفير تمويل يتيح لهم تنفيذ هذه الأنشطة، التى لم تكن قد لقيت رواجا شعبيا أو حتى إعلاميا بعد حتى قرب نهاية الثمانينيات.
قبل أن تطوى الثمانينيات أوراقها، كانت المتغيرات تتوالى على المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فاستقال الدكتور شريف حتاتة من منصب الأمين العام، وخلفه الدكتور عبدالغفار خلاف، الذى لم تكمل مدة توليه منصبه العام، ليختار مجلس الأمناء الصحفى الشاب بهى الدين حسن قائما بأعمال الأمين العام، ثم أمينا عاما عقب وفاة الدكتور خلاف، وكان للأمين الجديد بصمته الواضحة فى مد جسور التواصل مع الخارج، عبر شبكة واسعة من نشطاء حقوق الإنسان فى الغرب على وجه التحديد، وواجه بهى دعوات البعض داخل مجلس الأمناء بحل المنظمة أو دمجها فى جمعية أخرى، لتنعقد الجمعية العمومية للمنظمة فى مايو من العام 1989 بنقابة الصحفيين، وتعلن تمسكها باستمرار نشاط المنظمة ورفضها تجميدها أو حلها، كما انتخبت الجمعية العمومية مجلسا جديدا للأمناء، ضم فى غالبيته مجموعة من شباب الحركة الحقوقية وقتها.
ولم يكن صيف العام 1989 عاديا سواء بالنسبة لمصر بشكل عام أو للحركة الحقوقية بشكل خاص، وإنما كان صيفا ساخنا للغاية، بسخونة أفران الحديد والصلب، التى اندلعت فى مصانعها بحلوان انتفاضة عمالية، تضامنت معها الحركة الحقوقية، ودفعت ثمنا لهذا التضامن باعتقال عدد من نشطائها، وبينهم اثنان من أعضاء المجلس التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وهما الراحل الدكتور محمد السيد سعيد وأمير سالم، ليفتح نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومن دون أن يقصد الباب واسعا أمام الحركة الحقوقية الناشئة فى أن تثبت تواجدا فعالا على الساحة الداخلية، وأن تلفت مزيدا من انتباه العالم، وفى القلب منه عاصمة القرار فيه واشنطن، بعد أن سارعت المنظمة المصرية إلى خوض حملة يصفها المحامى نجاد البرعى بأنها كانت مزدوجة عبر استكمال الدفاع عن الضحايا والمعتقلين من عمال الحديد والصلب وفى الوقت نفسه تصعيد المطالبة بالإفراج عن نشطائها، وسرعان ما حققت الحملة النجاح بتراجع النظام الحاكم عن إجراءاته القمعية، وإفراجه عن المعتقلين الذين تعرضوا لصنوف شتى من التعذيب، تم توثيقها فى مؤلفات لعدد منهم وقتها.
دخلت الحركة الحقوقية المصرية بعد هذا المنعطف فى مرحلة جديدة بعد أن صارت محط أنظار مختلف القوى والأحزاب والتيارات السياسية، التى لم تكتفى فقط بأن يكون عدد من رموزها ضيوفا على فعاليات ومنتديات الحركة، وإنما سعت إلى أن يكون لها نصيبها داخل دائرة اتخاذ القرار فى المنظمة المصرية، فتزايدت أعداد العضوية من عناصر هذه التيارات داخلها، وهو ما انعكس بدوره على تشكيلات مجالس أمنائها.
ومع التواجد الحزبى والسياسى داخل صفوف الحركة الحقوقية، بات عليها أن تبحث عن صياغة علاقتها بالدولة المصرية فى ذلك الوقت، فهى من ناحية تضخ دماء جديدة فى شرايين إثارة قضايا تتماس مع الدولة بشكل مباشر كالحديث عن الديمقراطية والحريات وفى القلب منها حرية الرأى والتعبير، ومن ناحية أخرى فإن وجود منتمين لتيارات وأحزاب سياسية جعل صياغة العلاقة من جانب الدولة يتخذ منحى مختلفا، ويتمثل فى النظر إلى صفوف الحركة الحقوقية على أنها «حبلى» بمنافسين، وكثير منهم مؤهلين لخوض منافسات انتخابية فى مستويات مختلفة «محلية ونيابية ونقابية»، وفوق كل هذا وذاك فإن مجرد الحديث تحت شعارات حقوقية كان فى حد ذاته مثيرا للقلق لدى حكومة مبارك، بعد أن طرح النشطاء أنفسهم كراصدين ومراقبين لسلوكيات الدولة وأدائها، ومع تلويح واضح بعلاقات زاد نموها بدوائر مختلفة فى الغرب.
فى التسعينيات من القرن الماضى ومنذ بدايتها، دخلت الحركة الحقوقية طرفا فى المعادلة بالمشهد السياسى والاجتماعى أيضا فى مصر، وهى معادلة كانت تتمثل فى الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة، ومعارضة مقسمة بين تيار منظم هو التيار الإسلامى وبدأ فى التغلغل فى النقابات المهنية، وبين أحزاب كان الضعف سمة رئيسية لها، ومقاراتها وغرفها المغلقة عنوانا لأنشطتها، لتنضم الحركة الحقوقية إلى المعادلة حاملة معها اشكالياتها المتمثلة فى نخبويتها التى لم تكن تخفى على أحد من ناحية، وقضية التمويل، التى لم تفارقها يوما منذ النشأة، خاصة وأن نشطاء الحركة تمسكوا بالدفاع بكل السبل والوسائل عن حقهم فى جلب تمويل لأنشطتهم، رافعين شعار أن لذلك تأثيره فى دفع المجتمع فى اتجاه التطور الديمقراطى، وفى المقابل رأى منتقدو الحركة أن التمويل على العكس من ذلك أسهم فى إفراغ الحركة الحقوقية نفسها من كونها مؤسسات تناضل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى كيانات تبحث عن عقد المؤتمرات والمنتديات الممولة فى فنادق العاصمة فى البداية ومن بعدها فى المنتجعات والقرى السياحية بمختلف محافظات الجمهورية الساحلية.
مضت سنوات التسعينيات بين نظام حاكم أعطى انطباعا لمعارضيه بأنه لا يستجيب سوى لصوت الخارج، ولا يتراجع إلا تحت ضغط منه عن أى اجراء يتخذه، وصار الدعم الخارجى شرطا لنجاح أية تحركات معارضة لمبارك أو أية مطالب تتعلق بالحراك داخل المشهد المصرى، وهو ما تيقن له نشطاء الحركة الحقوقية مبكرا، ونجحوا إلى حد كبير فى استثمار خوف النظام الحاكم من أى تلميح بانتقاد خارجى لأوضاع داخلية، فكان استدعاء انتقاد المنظمات الدولية من ناحية والتصعيد من شأن انتقادات لسياسيين غربيين، وخاصة إذا ما جاءت هذه الانتقادات والملاحظات من البيت الأبيض.
وبدورها لم تتوقف الإدارات الأمريكية عن إظهار تواجدها فى مختلف المواقف والأحداث، التى جمعت ما بين أطراف فى الحركة الحقوقية من جانب والحكومة المصرية من جانب آخر.. وظهر الوجود الأمريكى واضحا فى قضية اتهام حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتلقى تمويل من الخارج، لكن الظهور الأكبر كان فى قضية أستاذ الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية، الدكتور سعد الدين إبراهيم مؤسس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.


هذا الخبر منقول من اليوم السابع
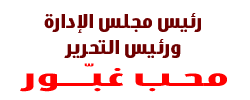

 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي






