تبدو الثقافة في أبسط تعريفاتها مجموع عناصر الحياة وأشكالها ومظاهرها في مجتمع من المجتمعات ، وتتألف من عنصرين أساسيين - كما قال قسطنطين زريق في كتابه الوعي القومي - أولهما معرفة صحيحة يكتسبها المرء بالجهد العقلي الداخلي وتتحقق من خلال اطلاع شامل متوازن على الفكر الأساسية التي تقوم عليها العلوم والفنون والآداب ، ومن علم متخصص متعمق في وجه من وجوه هذه الثقافة العامة . والعنصر الآخر هو تلك القوى العقلية والروحية التي بها يكتسب الإنسان المعرفة ويجعلها قسما من نفسه وشخصيته .
فالمثقف هو الذي يجمع في نفسه ثلاث خصائص :
- قدر معين من المعرفة المكتسبة .
- نهج عقلاني محدد في هذا الإكتساب .
-اهتمام بقضايا المجتمع القومي والوطني والعالمي الإنساني والإلتزام بمواقفه منها .
المثقف اليوم يتحدد لا بنوع علاقته بالفكر والثقافة ولا لكونه يكسب عيشه بالعمل بفكره وليس بيده ، بل يتحدد وضعه بالدور الذي يقوم به في المجتمع كمشرّع ومعترض ومبشّر بمشروع ، أو على الأقل صاحب رأي وقضية وموقف .
إن الفرق بين المثقف وغيره من المتعلمين الذين حصلوا قدراً معيناً من المعرفة المكتسبة ونهجوا نهجا عقليا في في هذا الإكتساب ، إذاً المثقف يهتم بقضايا المجتمع القومي والوطني والعالمي الإنساني ، والمثقف في جوهره إنسان مهتم ، إنسان يحدد ويحلل وينقد العوائق التي تقف أمام بلوغ نظام إجتماعي أفضل ، نظاماً أكثر إنسانية وأكثر عقلانية ، إنه بذلك يلج ضمير المجتمع ويصبح الناطق الرسمي بإسمه بشكل أو بآخر .
وفي الواقع إن ظهور المثقف لا يمكن أن يتم الاّ بظهور (الخلاف ) ظهور الآراء المتعددة والمتنوعة والمختلفة ، لقد ظهر الكلام مع ظهور الخلاف ، وعندما تبلورت قضاياه وتحددت ، وصار التكلم فيها بمنهجية وفي إطار مذّهب ، نضجت فيه المقالات ، فارتفع إلى مستوى العلم ، أي أصبح قابلاً للتصنيف والتبويب والعرض المنظّم ، وقد صادف ذلك ترجمة فلسفة اليونان وعلومهم في تزامن نضج مقالات المتكلمين الفلاسفة والفلاسفة المتكلمين ، ليحل محل الجيل القديم أصحاب الرأي والمقالات ، لقد ظهر الجيل الأول نتيجة انفصال العقيدة عن القبيلة ، وظهر الجيل الثاني نتيجة اصطدام العقيدة الدينية مع العقيدة العقلية اليونانية .
دار كلام المثقفين من المتكلمين الفلاسفة حول محورين رئيسيين :
- التسامح.
- التأكيد على حرية الإنسان . وبالتالي إقرار المسؤولية من جهة ثانية .
أمّا التسامح فيتجلى في تحديدهم معنى الإيمان . وطرحت هذه المسألة بشكل رسمي ومكثف في زمن الحرب بين سيدنا علي وسيدنا معاوية حين اعتزل الفتنة كثير من الصحابة . كما طرحت عندما أسلمت شعوب بأكملها بواسطة الفتوحات ولم تكن تعرف العربية ولا الحلال ولا الحرام . وأمّا حرية الإنسان فتجلت في فكرة ( المنزلة بين المنزلتين ) المنبثقة من أصحاب القول بفكرة القضاء والقدر ، وفي هذا الصدد يذكر إبن قتيبة أن معبد الجهني وعطاء بن يسار دخلا على الحسن البصري وقالا ( ياأبا سعيد هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون أموالهم ويقولون إنما تجري أعمالنا على قدر اللّه تعالى ).
وهناك فئات اخرى من المتكلمين والفلاسفة في عداد مثقفي الأجيال الأولى للحضارة الإسلامية ، من بينها فئة تجندت للدفاع عن العرب والمسلمين ورد هجمات الشعوبية والمانوية ، وفئة وقفت إلى جانب الإمام الشيعي الأكبر جعفر الصادق ، واخرى حول إبنه إسماعيل ، فشيدت ثقافة بأكملها هي الثقافة الشيعية بكل تلويناتها ومنازعها ، وفئة جسدت نموذج المثقفين الذين يستهلكون الثقافة ويروّجونها ، ولكن من دون الإرتباط بقضية بعينها ، إنهم مثقفو (( المقابسات )) الذين يعكسون اللامركزية الثقافية والسياسية ومن بينهم أبو حيان التوحيدي واستاذه أبو سليمان السجستاني المنطقي .
يزخر التاريخ العربي الوسيط بفائض من نماذج المثقفين الذين إرتبط بعضهم ببلاط الخلفاء والسلاطين فشكّلوا ذلك الصنف الذي يسميه غرامشي ( المثقفين العضويين التقليديين ) وارتبط بعضهم الآخر بالعامة فشكّل ذلك الصنف المعارض للسلطان ، والذي يسميه غرامشي ( المثقفين العضويين الجدد ) ولكن هذا الفيض لم يقتصر على التاريخ العربي الاسلامي الوسيط وإنما تعداه إلى التاريخ الحديث ، فقهاء السلاطين وكتّابهم ومؤرخوهم وأعضاء مجالس انسهم من ادباء وشعراء وقصّاصين الذين يقومون للسلطان بدور أدوات الهيمنة والترويج لسلطانه ، ما زالوا هم إياهم اليوم .
أمّا الفئات المعارضة من علماء وفقهاء وخوارج وغلاة متصوّفة فما زالوا هم إياهم اليوم أيضا وإن إختلفت التسميات .
وكما التزم المتكلم والفيلسوف في العصر الوسيط برسالة الشرع داعيا العامة إلى فهمها والتقيد بها في شؤون الدين والدنيا ، كذلك التزم المثقف العربي الحديث برسالة النهضة والتقدم داعيا الجماهير إلى تحقيقها متخذاً من الفكرة القومية أو الوطنية أو الديمقراطية الإطار المرجعي لصناعة مشروعه .
لقد انصرف الفقيه التقليدي إلى برنامج دعوى يخاطب المؤمنين مستنفراً فيهم عقيدتهم ومشاعرهم الوطنية والقومية ؛ ليس الخلاف بينهما كبيراً في المنطق ، كل منهما داعية وصاحب رسالة أو مشروع ، ربما كان الخلاف بينهما في نوع الأدوات التي توسلا بها لاستمالة الجمهور .
تتجلى صورة المثقف الحديث في شخصية رجل التنوير أو المجد الذي يتوقف نفوذه وسلطته على مقدرته في نقل العلوم والأفكار والقيم والمؤسسات الحديثة والجديدة من الخارج . ففي العديد من الأقطار العربية لعب المثقفون أكثر من أي طبقة أو نخبة إجتماعية اخرى دورا ريادياً في تجديد الأفكار والعلاقات الإجتماعية في المجتمعات الراكدة بفعل إحتكاكهم بثقافة العالم ا لحديث ا لاوروبي ومكتسباته التاريخية والتقنية والعلمية والسياسية . وكان للمثقفين الفضل الأكبر في دفع المجتمعات إلى القطيعة مع العقائديات الاجتماعية القديمة ، والفضل في إعادة إحياء التراث الثقافي المدني والعقلاني الذي كان قد دفن تحت ركام مدارس قديمة ، لكن هذه الصورة المتجلية في شخصية رجل التنوير مالبثت أن استبدلت في مطلع القرن الماضي بصورة مثقف التحرر الوطني ؛ ومثقف النضال القومي على إختلاف توجهاته الفكرية .
إنّه ذلك المثقف الذي تفتح وعيه على صدمة الاستعمار والهيمنة الغربية على عالمه القومي ، وارتبط صعود هذا النوع من المثقفين بحركة التحرر الوطني . أمّا مثقف النضال القومي فقد إرتبط صعوده بمرحلة بناء ما سمّي بالدولة الواحدة واستعادة الأراضي المحتلة ، والوقوف ضد المشاريع الدخيلة والمشاريع التوسعية ، ومع صعود هذين النوعين من المثقفين تراجع نموذج المثقف المجدد والمثقف التكنوقراطي ، غير أن تعقيدات الواقع العربي كعلاقة القطري بالقومي وتعقيدات الصراع العربي الإسرائيلي وظروف النهج العالمي الجديد ، جعلت جميع هذه النماذج من المثقفين تتراجع لصالح ( الموظف الحزبي ) ذو الولاء المطلق ، وليس المثقف المستقل ذا العقل النقدي الخلاّق ، ذلك المثقف الناصح الأمين والغيور على المصلحة العامة .
وعقب حقبة المثقف الموظف جاءت حقبةالمثقف المدجن الذي يسعى وراء الرزق والمال والرفاه الفردي أيّا كان مصدره . هذه النماذج قد لا تكون النماذج الوحيدة التي ينضوي تحتها المثقف العربي ؛ فهناك المثقف الديمقراطي ومثقف الطبقة والمثقف الوطني والمثقف القومي . إنها نماذج يمكن ردها إلى دائرتي الإلتزام والانتفاع اللتين يصدر عنهما كل مثقف مراهناته أو رهانه على عمليتي التغيير أو إنتفائها .
إن منابع تجربة المثقفين العرب القديمة ، والمطّلع على تجربة المثقفين العرب المعاصرة ضمن دائرتي الانتفاع والالتزام لا بد له الاّ أن يكتشف أوجها من الخلل في سلوكهم الثقافي أزاء المجتمع العربي . منها النزعة النخبوية الأكاديمية التي تتخذ شكل عزوف عن الخوض في الشؤون العامة بدعوى استقلال نظام المعرفة عن نظام الممارسات الاجتماعية . أو تتخذ شكل حياد بارد في تناول القضايا الاجتماعية العربية بدعوى وجوب احترام الموضوعية والامانة العلمية من أي مظهر من مظاهر الانحياز الايديولوجي . ومنها النزعة الإختزالية التي تضخم استعمال أدوات التحليل الطبقي لكل الظواهر الاجتماعية من دون أدنى مراعاة لمدى ملاءمة أو عدم ملاءمة جهازها المفاهيمي للموضوع المتناول بالدرس . ومنها أيضا النزعة الحزبية التي تخضع ظواهر العقل الاجتماعي السياسي والثقافي لمنطق المؤسسة التي ينتمي اليها الموظف أو المثقف . ومنها أخيراً النزعة التي تتمثّل عند المثقفين بتقديس الشعب من هو مالك الحقيقة ومنبعها الأوحد ، والمعيار الذي على موقفه تقاس كل المواقف والاختيارات .
إن بعض أوجه الخلل في السلوك الثقافي للمثقف الحديث ازاء المجتمع العربي يرتبط ولا شك بطبيعة المرحلة التي عاشها هذا المثقف من النهضة ومن الاستقلال ومن التحرر . فبعد ان كان ينظر اليه كحامل أفكار إصلاحية صار ينظر إليه أن له رسالة في التغيير ، ونشر الأفكار والقيم الحديثة وترقية العقل والوجدان وتحديد الأخلاق العامة . صار ينظر إليه على أنه العارف بالحقيقة وموقظ الوعي وضمير المواطن والمؤثر في الرأي العام الذي هو سنده للتأثير في مراكز السلطة .
هذه النظرة إلى هوية المثقف ودوره تبعتها نظرة اخرى إلى القضية التي يجب أن يدافع عنها ، حيث لا يمكن للمثقفين بطبيعة الحال أن يتفقوا على رأي أو مذهب واحد ، وإنما الذي ينبغي أن يتفقوا عليه جميعا هو دفاعهم عن الحق في حرية التعبير ، أي أن قضيتهم المشتركة هي الديمقراطية ليس باعتبارها مذهبا من مذاهب اخرى بحيث يختارونها أو لا يختارونها ، بل هي قضيتهم لأنه بغيرها ينتفي الشرط الأساسي للكتابة والإبداع ، أي الحرية ، بكلام آخر ينبغي أن يكون هناك إذاً وفاق عام بين سائر المثقفين ، وهو الوفاق على الديمقراطية . وبعد ذلك فلتختلف الآراء والمذاهب وليكن هذا الحق في الاختلاف مشروعا للجميع .
عندما تضيع الفروق بين الاعتقاد الحقيقي وبين النفاق ، وبين الثبات على المبدأ أو الثبات على المبلغ ، يفقد المثقفون وأهل الرأي مصداقيتهم في أعين الناس ، أمّا عندما تظهر الفروق ويظهر الذين ينتصرون للحرية وللديمقراطية ، ولحرية الرأي ولحرية الإعلام ، يستعيد المثقفون وأهل الرأي مصداقيتهم في العمل على التغيير والتحرر من المطبات السلطوية وتنمية المجتمع بشكل عادل وسليم بعيدا عن النفاق والتسلق والدجل السياسي .


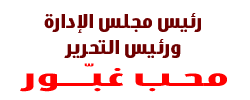
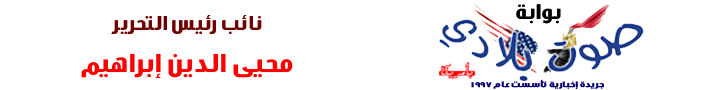
 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي









