كثيرة هى الانتقادات الخارجية, التى تعرضت لها مصر فى الآونة الأخيرة متعمدة الإساءة إلى الدولة, منظمات حقوقية دولية تحمل أجندات خاصة وتقارير مسيسة تقف وراءها حكومات دول معادية وغيرها من أمور مشابهة, لا نواجهها بالجدية المطلوبة, بل نتصدى لها فى الغالب بإعلام غير مسئول, يمتلك صوتا عاليا, ولكنه فارغ من المضمون, أو نكتفى بوضعها ضمن إطار نظرية المؤامرة فى قوالب جاهزة نمطية غير مقنعة لغيرنا, ولا تصلح سوى للاستهلاك المحلي, ورغم ذلك فليس هذا ما يتوقف عنده هذا المقال, وإنما عند مظاهر أخرى تحدث فى الداخل وتُسهم, حتى دون قصد, فى رسم صورة سلبية عن الدولة المصرية.
لنأخذ بعض الأمثلة لقضايا فرضت نفسها على ساحة النقاش العام طوال الأسابيع الماضية, أقل ما تُوصف به أنها لا تليق بدولة فى حجم مصر, كانت دوما مثالا يُحتذى ونموذجا مستنيرا رائدا لمحيطها الإقليمى كله, يأتى فى مقدمتها, الإصرار على إشاعة خطاب دينى شديد الجمود ومنهج فى التفكير يخاصمه العقل يندرج تحت بند الفتاوى الشاذة المناقضة للحس الإنسانى الطبيعي, التى أفتى بها بعض أساتذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر, واستوجبت فى النهاية, بعدما شغلت الرأى العام بقضايا وهمية, ردا من دار الإفتاء بتحريمها وعدم شرعيتها, إلا أن ذلك وحدة ليس كافيا, فمن أصدروا مثل تلك الفتاوى استندوا إلى كتب الفقه والتراث, التى تحوى أحكاما تفصلنا عنها قرون زمنية وكانت نتاجا لسياقها التاريخى الذى وُجدت فيه, والذى اختلف يقينا عما نعايشه اليوم. إن الرد الحقيقى الجامع عليها كان فى إعلان مؤسساتنا الدينية البدء فى تنقية ومراجعة مثل هذه الكتب من المنبع وليس تتبع كل فتوى على حدة, وإلا فما معنى الحديث عن تجديد الخطاب الديني, الذى لم نُنجز فيه شيئا وتحول إلى مجرد شعار, بالمقارنة اتخذت تونس على سبيل المثال خطوات جريئة فى مجال التشريع الخاص بالمساواة بين الجنسين فى علاقات الزواج والمواريث, مستفيدة من تراثها العلمانى الذى أرسته تجربة بورقيبة لتستعيد هوية دولتها الوطنية الحديثة على الرغم من مشاركة حزب النهضة الإسلامى فى الحكم هناك, صحيح أنه صدر بيان رافض من الأزهر لها على اعتبار أنها نابعة من التجربة التونسية الذاتية ولا تخُص غيرها, إلا أن المعنى المهم المستخلص هنا, أن هناك تطويرا وإصلاحا تستهدفه الدول, ونفس الشىء ينطبق على السعودية (القياس مع الفارق) بالسماح للمرة الأولى فى تاريخ المملكة مساواة المرأة بالرجل فى حق قيادة السيارات, إنه التقدم للأمام لا الرجوع إلى الخلف.
هذا الحديث ينسحب أيضا على الضجة التى أثيرت حول الشيخ الأزهرى الذى تغنى بإحدى أغنيات أم كلثوم وأحيل للتحقيق بسببها, و كذلك قانون ازدراء الأديان, الذى أهملناه وأُغلق ملفه فى إشارة واضحة لترك الحال على ما هو عليه, ليكون سيفا مسلطا على كل صاحب رأى يسعى إلى الاجتهاد والتغيير.
قضية ثانية, تتلخص فى منع إقامة بعض المواطنين الأقباط فى إحدى القرى بمحافظة المنيا من الصلاة داخل أحد المنازل (لأنه غير مرخص ككنيسة), بدعوى إثارة مشاعر المسلمين أو بالأحرى المتطرفين, رغم أن مصر قطعت شوطا مهما فى اصلاح قانون دور العبادة كان محل حفاوة داخليا وخارجيا, فلماذا تقع مثل هذه الحوادث عديمة الجدوى والمعني, إن الانتهاء الفعلى من تحكم قوى الإسلام السياسى لن يكون إلا بالتخلص من منهجهم فى التفكير وليس فقط بخروجهم من السلطة.
قضية ثالثة, تتعلق بمقترح تعديل قانون الجنسية المصرية (رقم 26 لسنة 1975) الذى تقدمت به الحكومة ليُعرض على البرلمان فى دورته الحالية, و تضمن توسيع حالات إسقاط وسحب الجنسية, التى ذكرها على النحو التالى « كل من اكتسبها عن طريق الغش, أو بناء على أقوال كاذبة, أو صدر حكم قضائى يثبت انضمامه إلى جماعة, أو جمعية, أو جهة, أو منظمة, أو عصابة, أو كيان, أيا كانت طبيعته, أو شكله القانوني, سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها, وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة, أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادي, أو السياسى لها بالقوة, أو بأى أساليب أخرى غير شرعية» وفى فقرة ثانية, تمت زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتجنس أو الزواج, وثالثة تتضمن صدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة.
الملاحظة الأساسية هنا ليست مساءلة الدولة حول حقها فى حماية أمنها القومي, ولكن فى هذه العبارات الفضفاضة التى صيغ بها المقترح الحكومي, والتى ستكون بالقطع محلا لخلافات عميقة حول تفسيرها وتعريفها, وكذلك هذا التوسع غير المسبوق فى حالات إسقاط الجنسية التى سيُطعن بعدم دستوريتها لتعارضها مع المادة السادسة من الدستور من ناحية, ولبعض مواد الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية, والتى ستجر على مصر مزيدا من الانتقادات الخارجية هى فى غنى عنها من ناحية أخري. كان من المفترض أن يقتصر هذا التعديل على الحالات التى تم فيها منح الجنسية بقرار سيادي, وهو ما تم بالفعل إبان حكم الإخوان لأسباب سياسية بحتة, حتى يكون هناك منطق واضح بل ومشروع يمكن الاحتكام اليه.
قضية رابعة, ترتبط بدور مصر الإقليمى خاصة فيما يتعلق بالوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين, وهو دور ريادى اكتسبته بعد توقيعها معاهدة السلام مع إسرائيل وتستعيده الآن بقوة, وتكفى الإشارة إلى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الخصوص الذى ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, فى الوقت الذى لايسيطر على الساحة الداخلية سوى خطاب سياسى واحد مناقض لهذا التوجه من حيث المبدأ, موروث من الحقبة الناصرية ويحتل المساحة الأكبر فى وسائل الإعلام بشكل يكاد يكون أحاديا بل إن كل من يشغل المواقع القيادية الإعلامية ويوجه الرأى العام ينتمى لنفس الاتجاه, وهو نوع من الازدواجية لم تعد تستفيد منه الدولة, وليست بحاجة إليه.
هذا بعض من كل مما امتلأت به ساحة النقاش العام, وفيه إساءة للدولة ولكننا نفعلها بأنفسنا, وإصلاحها لن يكلف الدولة الكثير أو يشكل خطرا عليها, بل على العكس سيضعها فى مكانة أفضل تستحقها, فقط يحتاج الأمر إلى قدر من الحسم ووضوح فى الرؤية لما نريد أن نصبح عليه فى المستقبل.
طريق المصالحة
بعد انقسام دام لما يقرب من أحد عشر عاما نجحت مصر فى دفع حركتى فتح وحماس لتوقيع اتفاق القاهرة تحقيقا للمصالحة الداخلية التى تأخرت كثيرا، وكخطوة أولى رئيسية لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعدما توارت فى خضم الصراعات الإقليمية التى تشهدها المنطقة، وهو إنجاز سياسى كبير يُحسب لها. وبموجب الاتفاق ستتمكن حكومة الوفاق برئاسة رامى الحمد الله، التى ستتسلم مهامها ديسمبر المقبل، من بسط سيادتها على قطاع غزة الواقع تحت إدارة وسيطرة حماس منذ 2007، أى بعد آخر انتخابات أجريت قبل ذلك بعام فازت فيها الحركة وأقامت حكومة أمر واقع أو حكومة ظل من خلال ما عُرف باللجنة الإدارية، التى تم حلها أخيرا، كذلك نصت بنوده، التى ستعالجها الجولات القادمة، على دمج الأجهزة الأمنية فى الضفة والقطاع، وتسليم المعابر الحدودية لحرس الرئاسة الفلسطينية، فضلا عن إعادة تسكين موظفى غزة الذين عينتهم حماس ويبلغون قرابة الخمسين ألف موظف، إلى جانب تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.
هذه القضايا كلها كانت موضوعا لجميع الاتفاقات التى سبق عقدها بين الجانبين بدءا من اتفاقية مكة التى رعتها السعودية (2007) وصولا إلى اتفاق الشاطئ (2014) الذى تم فى غزة ، إلا أنها تعثرت بسبب الانحيازات والتحالفات الإقليمية السابقة لقيادات حماس والتى وضعتها فى خندق إيران وسوريا وحزب الله، الممانعين لعملية السلام من حيث المبدأ، ثم قطر، التى أضحت من أهم داعمى وممولى الحركة بعد خلافها مع نظام بشار، بل واتخذت من الدوحة مقرا لكثير من اجتماعاتها وإقامة كوادرها فيها.
فى الآونة الأخيرة، طرأت معطيات كثيرة، دولية وإقليمية ومحلية، مهدت لتغيير مواقف الطرفين (فتح وحماس) وتخفيف الخصومة بينهما، فحماس تعانى عزلة على المستوى الدولى كونها مُدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية، كانت تعوضها دوما بتحالفاتها مع بعض القوى الاقليمية، التى تتنقل بينها، إلا أن تعرض قطر لمقاطعة الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر على خلفية اتهامها بدعم التنظيمات الإرهابية، أثر بلا شك على دورها المساند لحركة حماس من ناحية، ومن ناحية أخرى عانى القطاع تدهورا شديدا فى أحواله الاقتصادية والمعيشية بعد الاجراءات العقابية التى فرضتها السلطة الفلسطينية والمتعلقة بإمدادات الوقود والكهرباء وصرف الرواتب، كنوع من الضغط السياسى على حماس، والأكثر من ذلك هو توتر علاقات الأخيرة بمصر، أهم قوة إقليمية تعتمد عليها للإبقاء على معبر رفح مفتوحا، بسبب قضية الأنفاق التى تُستغل فى تهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية إلى سيناء، فضلا عن علاقاتها الوثيقة بجماعة الإخوان.
وقد مهدت حماس لهذا التغيير بإصدارها أبريل الماضى وثيقة تعديل بعض نصوص ميثاقها الأساسي، الذى اعتمدته منذ تأسيسها أواخر الثمانينيات، لتؤكد رغبتها فى الانفتاح على العالم والغرب تحديدا، والقبول بدولة فلسطينية مؤقتة على حدود 1967 تكون عاصمتها القدس، واستقلال قرارها عن الجماعة باعتبارها حركة تحرر وطنى فلسطينية.
فى المقابل، لم يكن محمود عباس (أبومازن) رئيس السلطة، أقل حاجة من حماس إلى التغيير بعد الجمود الطويل الذى خيم على مفاوضات السلام منذ اتفاقية أوسلو(1993)، التى لم تؤد إلا إلى انسحاب جزئى من الضفة الغربية وهى المنطقة (أ) وبقيت المنطقتان (ب) و(ج) خاضعتين للاحتلال مع الاستمرار بشكل مطرد فى سياسة الاستيطان، وربما يرى فرصة الآن لاستكمال المفاوضات بعد ما أبدته الإدراة الأمريكية الجديدة لدونالد ترامب من رغبة فى الوصول إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطينى الإسرائيلي.
هذه هى بعض الأسباب الموضوعية التى رجحت كفة المصالحة، ولكن تبقى هناك قضايا محورية ستفرض نفسها على المدى الأطول وتتطلب اهتماما خاصا فى مقدمتها، وضع الجناح المسلح لحماس -الذى لم يتطرق إليه اتفاق القاهرة - ويقدر بآلاف المقاتلين، وتعتبره الحركة خطا أحمر وسلاحا شرعيا للمقاومة لا يمكن المساس به وغير قابل للتفاوض، وهو نفس ما سبق أن أكدته فى وثيقتها المشار إليها كخيار إستراتيجى لها، مما دعا أبو مازن للتعبير صراحة عن خشيته أن تتحول حركة حماس إلى «حزب الله» آخر فى فلسطين، بمعنى أن تُخلصها حكومة الوحدة المزمع تشكيلها من أعباء حكم القطاع المعيشية دون أن تُفقدها قدرتها على الانفراد بقرارها المستقل، وهذا بالضبط هو نموذج حزب الله فى لبنان، الذى لم يتخل أبدا عن ميليشياته المسلحة جنبا إلى جنب مع جناحه السياسى ومشاركته فى الحكم، حتى تحول إلى الرقم الصعب فى معادلة السلطة وامتلك حق االفيتوب على أى قرار سياسى وتمكن من تعطيل الانتخابات الرئاسية هناك لأعوام.
هذه القضية بالذات ليست مجرد قضية فلسطينية داخلية، ولكنها ستكون المعيار الرئيسى للحكم على جدوى المصالحة دوليا، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ونفس الشيء ينطبق على مسألة الاعتراف بإسرائيل والقبول بالبرنامج السياسى للسلطة الفلسطينية كونه أساس التسوية السلمية وشرط لحاقها بأوسلو، وتبدو حماس إلى الآن متمسكة ببرنامجها الخاص وبعيدة عن هذا التوجه وما يرتبه من التزامات تعهدت بها السلطة الفلسطينية، وهذه قضية ثانية.
قضية ثالثة، وتتعلق بالانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة منذ 2006، وهنا تثار تساؤلات حول التنافس المعلن بين تيار القيادى السابق فى حركة فتح المنشق عليها والحليف الحالى لحماس محمد دحلان وبين تيار محمود عباس الممثل للسلطة الحالية، فالأول اكتسب شعبية فى غزة، كما أن لكل منهما تحالفاته الإقليمية ورهاناته التى تعزز من موقعه ونفوذه السياسي. فهل نتحدث هنا عن بديل؟ أم أن هناك مصالحة فرعية يجب أن تُجرى بين الطرفين، ومع من ستقف حماس؟
تبقى قضية التحالفات الإقليمية، صحيح أن دور مصر هو الحاكم والأساس فى الدفع بالمصالحة الفلسطينية وهى أيضا الوسيط أو الطرف الثالث فيها، ولكن ماذا سيكون مصير تحالفات السلطة الفلسطينية وحماس كل على حدة مع دول أخرى فى الإقليم ليست على علاقة جيدة بالقاهرة، مثل تركيا فى الحالة الأولى وقطر فى الثانية، التى حرص رئيس مكتبها السياسى إسماعيل هنية على إطلاع أمير دولة قطر على ما نص عليه اتفاق المصالحة فورتوقيعه، وهو ما يحمل فى طياته كثيرا من التناقضات.
لاشك أن طريق المصالحة مازال طويلا، وهو أمر متوقع، لكن المهم أن البداية قد حدثت.


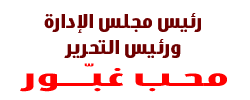

 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي









