احتفى كل مَن عانى من سياسات الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما بهزيمة مرشحة الحزب الديمقراطى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التى جرت فى نوفمبر من العام الماضى، وتضاعف الاحتفاء بإعلان فوز المرشح الجمهورى دونالد ترامب، من منطلق أن المرشح الفائز سوف يقوم بتغيير دفّة السياسة الأمريكية ويبعدها تماماً عن خط «أوباما»، وأن الرجل يعد عدواً لجماعة الإخوان، وسبق أن أعلن إبان حملته الانتخابية أنه سوف يعلن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وقد كشفت اللقاءات التى أجراها مع قادة عرب، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، قُبيل الانتخابات، عن أن للرجل رؤية مناقضة تماماً لرؤية الإدارة السابقة التى عانت منها مصر كثيراً، وتسببت فى تمزيق العديد من الدول العربية.
بعد تسلّم الرجل لمهامّ منصبه بدا واضحاً أنه يقود دفة السياسة الأمريكية من منطلق رجال الأعمال الذين يحسبون كل خطوة بحساب المكاسب والخسائر المباشرة، فالرجل ركز على حلول عاجلة لمشكلات الاقتصاد الأمريكى، عبر إبرام صفقات مع دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، ثم لفّ على باقى دول الخليج وحصل على صفقات هائلة، تلاعب بالتناقضات العربية، وحصل من قطر على صفقات أيضاً، واستغل الخلافات «القطرية - السعودية، المصرية، الإماراتية، البحرينية» فى الحصول على المزيد من الصفقات، تلاعب بالجميع فى حين ظل جوهر السياسة الأمريكية على حاله، لم تحدث تغييرات جوهرية فى توجهات السياسة الأمريكية نحو المنطقة، بل إن كل التفاؤل الذى ساد ببدء مرحلة جديدة من العلاقات مع روسيا الاتحادية، سرعان ما تبدّد، بل وشهدت العلاقات مزيداً من التدهور فى ظل إصرار المؤسسات الأمريكية على اتهام روسيا الاتحادية بالتدخل فى الانتخابات الرئاسية لمصلحة «ترامب»، ووقف الأخير عاجزاً عن مجرد منع استمرار التدهور فى العلاقات مع موسكو.
خلاصة الأمر أن «ترامب» حتى هذه اللحظة بدا كظاهرة صوتية أكثر منها شخصية سياسية بمقدورها إحداث تغيير فى توجهات السياسة الأمريكية، وبعيداً عن مآل الجهود الرامية إلى إقصائه، نقول: إن الرجل لن يؤثر فى توجهات السياسة الخارجية الأمريكية، وإن مؤسسات الدولة هى الأكثر قدرةً وتأثيراً، والخطأ كل الخطأ فى إهمال مؤسسات الدولة رهاناً على علاقة ودية متصورة لدينا نحن ولدى صانع القرار الأمريكى، فما هكذا تدار دفة الأمور فى الدول الكبرى ذات المؤسسات الديمقراطية، فالشخص هناك يمكن أن يؤثر، ولكن المؤسسة أقوى، وتأثيرها أكثر، وهى الأبقى.
مصر فى مفتـرق طرق
هناك فجوة كبيرة بين مواد الدستور المصرى التى تنص على قيم المواطنة، والمساواة، وعدم التمييز بسبب الدين، والعِرق، واللغة، والطائفة، وبين ما يمارَس فى الواقع من سياسات مضادة لكل ذلك، سياسات تُميز بين المواطنين بسبب عوامل الانقسام الأولية الموروثة، وأيضاً الثانوية المكتسبة من طبقة اجتماعية وانتماء وتوجّه سياسى. يتحدث الدستور المصرى عن دولة مدنية، فى حين أن الواقع المعيش فى مصر اليوم هو خليط ما بين دولة مدنية من حيث نصوص الدستور ولغة خطاب المسئولين، ودولة دينية من حيث الواقع المعيش والسياسات العملية الممارسة، فالدولة وفق بنيتها المؤسسية أقرب ما تكون إلى دولة دينية منها إلى دولة مدنية، فللدولة مهام دينية، كما أنها تمارس المحاصصة والتمييز الدينى والطائفى، بحيث إنها تغلق الباب تماماً أمام مواطنين مصريين، وتحول بينهم وبين الالتحاق بجهات سيادية لمجرد كونهم مسيحيين، كما أن الدولة لا تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان، مثلما هو الحال فى الدول المدنية الحقيقية، ولكنها تختار لنفسها ديناً، وهى الكائن الاعتبارى المفترض أن يكون محايداً، الأكثر من ذلك أن الدولة، وفق بنيتها الساداتية المستمرة حتى يومنا هذا، تمارس التمييز على أساس دينى وطائفى، بل توظّف أدوات التنشئة من تعليم وإعلام وثقافة للترويج لديانة والإساءة لما هو دونها من ديانات وعقائد ومعتقدات، وأدى تديين المجال العام والإغراق فى التدين الشكلى إلى حالة متفاقمة من التعصب والتطرف على المستوى العام، وجرى تدريجياً زرع الكراهية تجاه المغايِر الدينى والطائفى على النحو الذى أفرز لنا ظواهر عامة للتطرّف والتشدّد برعاية رسمية واضحة.
تفاءل القطاع الأكبر من المصريين بثورة الثلاثين من يونيو التى أطاحت بحكم «المرشد والجماعة»، وشارك فيها مختلف فئات المجتمع المصرى، وراهنوا على بدء عملية تحوّل حقيقى باتجاه بناء دولة القانون والمواطنة، صبروا أربع سنوات، وكانوا يلتمسون للسلطة العذر بسبب انشغالها بالحرب على الإرهاب، ومواجهة المؤامرات الداخلية والإقليمية، برّروا عدم بدء نظام ما بعد 30 يونيو لسياسة جادة لبناء دولة المواطنة بالمشكلات التى ورثها هذا النظام من نظام «مبارك» ثم «الجماعة»، رفضوا تصديق أن النظام الجديد هو استمرار لما قبله، وأن جوهر التوجه واحد، وأن بنية الدولة دينية، ولا نية لتغيير ذلك، وعلى الأقباط أن يستمروا فى دفع الثمن والقبول بحالة مواطن من الدرجة الثانية، وهو ما لن يحدث بعد كل ما جرى، فالتغيرات التى يمر بها العالم والمنطقة تدفع الدول ذات البنية الدينية إلى التخلص التدريجى من هذه البنية، لأنها عبء شديد لا يمكن تحمّل ثمنه داخلياً وخارجياً، ويكفى متابعة ما يجرى فى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، لنعرف مآل الدول الدينية فى منطقتنا.
فى تقديرى أن بلادنا تقف فى مفترق طرق حقيقى، وأمامها فرصة نموذجية لتخرج من «دولة السادات الطائفية»، وتبنى دولة قانون ومواطنة، فتحقق قفزات حقيقية على مقياس التقدم والتحضّر، والأحداث القادمة فى بلادنا ستثبت ذلك، فنحن فى مرحلة تراجعت فيها سطوة المؤسسات الدينية على الأجيال الجديدة التى تبحث عن التحقق الذاتى بعيداً عن خلطة الدين والسياسة، بعد أن جرى تديين جميع الظواهر والمظاهر فى البلاد دون تحسّن حقيقى فى أى مجال من المجالات المتعلقة بالتطور الحقيقى، فهل ستضيع الفرصة ونغرق أكثر فى مستنقع الدولة الدينية التى تحاول دول فى المنطقة الرجوع عنه بعد أن أيقنت أنها فى طريق الهاوية أم ستدفع بنا مؤسسات الدولة إلى مزيد من الاضطراب والفوضى ونصل إلى نقطة اللاعودة؟
أتمنى أن تكون الأحداث والجرائم الدينية والطائفية التى تجرى على أرض بلادنا جرس إنذار حقيقياً لمن بيدهم الأمر بأن السياسة الحالية ستقود حتماً إلى ما لا تحمد عقباه.


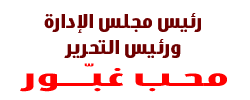

 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي









