عِيب على خريجي الجامعات نقصهم الظاهر في المستوى المعرفي، وتدني مخزونهم الثقافي، حتى صاروا يجهلون أموراً يلزم معرفتها لمن كان في سنهم أو أصغر منهم، ومن الضعف البين أن يقطع الطالب مرحلة طويلة في التعليم، وهو جاهل بالمعلومات الأساسية والمعارف الضرورية، ولئن كنا فيما مضى قد عانينا من أمية القراءة والكتابة -حتى كانت الأمية تؤرق جميع المصلحين والغيورين على الثقافة- فها نحن نعاني هذه الأيام من الأمية المقنعة، وهي أمية لا تقلّ خطورة عن سابقتها، وكما كنّا من قبل في حاجة لمحو أمية القراءة فنحن في أمس الحاجة لمحو أمية الثقافة!
لعلّ الأنظار تتجه حينما يُفتح موضوع الثقافة إلى (الجامعة) باعتبارها الجهة الرسمية التي تتحمل مسؤولية الثقافة ونشرها، وإن كنتُ أرى أن هذه النظرة لا تمثل الواقع الحقيقي لحجم المشكلة، لا يحاول أرباب هذه النظرة التفكير بعمق في جذور المشكلة وأساسها، نعم الجامعة مسؤولة عن توعية طلابها إلا أنّها ليست مسؤولية كاملة، وإذا كان من لوم حقيقيّ يوجه فالأولى أن يوجه إلى المدرسة بمراحلها (الابتدائية- المتوسطة-الثانوية) ذلك أن الجامعة يفترض أن تكون مرحلة للدراسة المتخصصة، ويخرج غالب الطلاب عادة من المدارس، وهم أميون ثقافياً ومعرفياً، بل لا يكتسبون مهارة القراءة الأساسية التي تتيح لهم الثقافة بأنفسهم، مما يحتم علينا أن تكون معالجة هذه المشكلة من أساسها في المدارس؛ بإشاعة حب القراءة بين الطلاب، فيخرج الطالب من مرحلة الدراسة وقد استوعب كثيراً من المعلومات، ولا ينقطع عن التزود من المعلومات مع دخوله الجامعة، وتصير الثقافة ملازمة له في حياته الدراسية بمراحلها المختلفة.
إن أردنا فعلاً القضاء على هذه الأمية الثقافية فلا بد من اتخاذ خطوات عملية ومدروسة، تبدأ أولاً من التكوين الثقافي لدى معلمي المدارس، ونشر الوعي بالقراءة؛ لأنّهم هم نواة إقبال الطلاب عليها، على أنّ أكثر الطلاب يجهلون قيمة الثقافة، ويكاد لا يوجد أحدٌ من معلميهم يحدثهم عن أهميتها، ولمعرفة الفارق بين المعلم فيما مضى والمعلم في وضعه الحالي أُحيلكَ على مقال الدكتور فؤاد زكريا "كيف حصلت على جائزتي الأولى؟" الذي نشر في مجلة (العربي) الكويتية العدد 492، سنة 1999م، حكى الدكتور قصة فوزه في مسابقة أقامتها وزارة المعارف [وهي وزارة التربية والتعليم آنذاك] لطلبة التوجيهية [الثانوية العامة] خلال الإجازة الصيفية، وكان للجائزة وقعٌ في نفسه وعقله.
كان الكتاب المقرر في مسابقة اللغة العربية "تاريخ الجبرتي"، ولستُ في صدد الكلام عن قراءة الدكتور للكتاب قراءة واعية، أو عن استيعابه لأحداثه، وإنما أتوقف عند قوله: "لم يكن العثور على "تاريخ الجبرتي" صعباً؛ لأنني وجدته في مكتبة المدرسة التي كانت عامرة بالمؤلفات القيمة، وساعدني أمين المكتبة على أن أستعير الكتاب بجزأيه طويلة الأمد". انتهى ما أردت ذكره من مقاله، ولك أن تتخيل طالباً في مرحلة الثانوية يطالع كتاباً في التاريخ وأحداثه العظام؛ كهذا الكتاب المتخصص، وإنّي أعدّ مقاله وثيقة هامة تجلي لنا بوضوح واقع الحياة الثقافية عند الطلاب في هذه المرحلة الزمنية، ويظهر من مقاله صورة المكتبة المدرسية في ذلك الوقت، حيث كانت عامرة بمثل هذه الكتب، الأمر الذي يفتقده بعض أماكن البحوث المتخصصة الآن، وتتجلى لنا قيمة المعلم في تذليل صعوبة القراءة لدى طلابه، الشيء الذي يغيب في مدارسنا.
أؤمن أن الثقافة مجهودٌ شخصي يقوم به الطالب نفسه، لكنّ طريق هذا المجهود يسهله المعلم، فيفتح لطلابه آفاق القراءة، وسبل الاطلاع؛ بحيث يحملهم عليها حملاً، فلا يدع باباً من أبواب الثقافة إلا دلهم عليه، أو طريقاً من طرق المعرفة إلا أرشدهم إليه، ولا شكّ أن المدارس في حاجة ماسة إلى ترسيخ سلوك القراءة لدى طلابها، وجعلها ضرورة يومية وحاجة ملحة.
إذا ما أردتَ جيلاً واعياً قارئاً فابحث أولاً عن معلمين قارئين، فائتني بمعلمٍ قارئ أُخرج لك طالباً قارئاً!


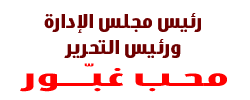

 رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
رئيس التحرير يكتب : من التراب وإلى التراب يعود .. تحويل جثث الموتى إلى سماد عضوى
 رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده
رئيس التحرير يكتب : لماذا تصر الحكومة على استمرار شريف أبو النجا رئيسا لمستشفى 57357 رغم الشواهد العديدة على فساده اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي
اقرأ في العدد الجديد ( عدد يناير ٢٠٢٣ ) من جريدة صوت بلادي









